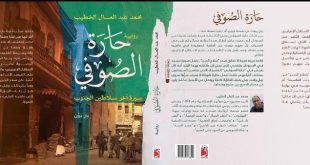مقالي غدا بالقدس العربي الأحد 10أكتوبر 2021 عن البشر والسحالي لحسن عبدالموجود
البشر والسحالي
سرديات المعرفة واجتراح النوع
عادل ضرغام
يعيد حسن عبدالموجود في كتابه (البشر والسحالي) تدوير الشفاهي والخرافي المنقول من جيل إلى جيل، ومن زمن إلى زمن، مكتسبا مشروعيته من دورانه أو بقائه مستمرا في أدمغة الناس مفسرا وجودهم وحركتهم ونزوعاتهم. وهذا الشفاهي المنفتح على الخيال يتفاعل مع أنساق الثقافة، ويأخذ مناحي جديدة تتوالد بالتدريج مولدة انعطافات جديدة تمارس وجودها، مبقية على استمرارها وديمومتها بأشكال مختلفة.
علاقة الإنسان بالحيوانات والطيور علاقة ممتدة، تختلف من عصر إلى عصر، باختلاف مساحات القرب والتواجد، ففي العصور البدائية الأولى تجلت هذه المساحة بشكل كبير، وشكلت هذه الحيوانات جزءا من عالمه، وغدت وسيلة لاستجلاب وتشكيل سرديات تفسيرية للكون والوجود. وأصبح فهم العالم بمكوناته لا يتمّ بعيدا عن سرديات هذه المكونات، فكل حيوان أو طائر له سردياته ومجموع حكاياته، ووعي البشر بتلك الكائنات وثيق الصلة بالحكايات والسرديات والأساطير والخرافات المقترنة به، سواء أكانت أساطير، أو أساطير تمّ دمجها وشحنها بما هو ديني ومقدس.
فالخرافة في الاعتقادات الأسطورية تؤدي دورا أساسيا في تقديم تصور عن العالم، من خلال تنميط حكاياته وسردياته، وحسن عبدالموجود في مجموعته لا يكتب قصصا عن الحيوان، وإنما عن الإنسان وعالمه المنفتح على جزئيات الوجود، وعن وعي هذا الإنسان في مرحلة عمرية أو في مراحل عمرية مختلفة، لأنه في قصصه لا يقدم وعيا واحدا، وإنما يقدم وعيا متحركا ممتدا وليس ساكنا، منها ما يبهت ويتحلل لأسباب عديدة، ومنها ما يستمر ويأخذ شكلا مختلفا.
وهذا يكشف عن المدى الفسيح الذي تتحرك فيه المخيلة البشرية، حيث تستند إلى قائمة طويلة متداخلة من الفلكلور الشعبي والقصص الشفاهية التي يتشكل في حدودها الوعي الإنساني. فما يقدمه حسن عبدالموجود في هذه المجموعة إنعاش لذاكرة، وتثبيت لطبقات معرفية، وانتصار لمخيلة حتى لو كانت في بعض توجهاتها تمارس تذويبا للأسطورة، وكسرا للمعهود والمقرر لاستناده إلى الحياة وحركتها فاسم (أبو دقيق) طبقا لمخيلة ودلالات الاسم يحمل معنى إيجابيا، ولكن طبقا لأثره الفعلي والسائد والمعهود والمقرر يحمل معنى سلبيا، ولكن الكاتب ينتصر لمخيلته، ولفتح دائرة دلالية جديدة تستند إلى الوعي الملازم للكلمة بحدودها الدلالية الأولى.
ولكنه في بعض القصص لا يكتفي بتقديم السرديات فقط، وإنما يقدم مساءلة مستمرة لهذا المستقرّ الذي تحوّل وتجلى في سلوك بشري بحثا عن التفسير، مثل النظرة إلى السحلية أو النظرة- متلبسة بأفق ديني- إلى الخنزير. فالنظرة السلبية إلى السحلية التي تجعلها هدفا دائما للقتل بالرغم من كونها كائنا غير مؤذ تعود في جانب كبير منها إلى معتقد شعبي، وإلى سردية قديمة تزعم أن الشخص الذي جمع الحطب الذي ألقي فيه إبراهيم عليه السلام مُسخ سحلية عقابا على سوء عمله.
سرديات المعرفة وتذويب الأسطورة
كتابة القصة في هذه المجموعة تعيد تشييد المعرفة أو الإدراك، فالكاتب يتوقف عند مساحات وعي ماضية وآنية، ويحاول أن يثبتها بوصفها تمثل حضورا يتغير شكله بالتدريج، وتكفل إدراكا معينا للواقع في كل فترة زمنية. والكتاب على هذا النحو نوع من أنواع التأمل والمعرفة والتفكير، فتأمل الحوادث وسردياتها يمثل بحثا عن أثر ما، أثر لا يمحى بل يستمرّ، لأنه وثيق الصلة بالروح، ويظل هذا الأثر فاعلا في تنميط العلاقة بين البشر والكائنات المحيطة.
فالوعي الإنساني لا يتشكل في فراغ، وإنما يتشكل وفق علاقات مشدودة إلى سياقات وحكايات لا ينفصل عنها، ومن ثم يأتي الاشتغال على الأساطير مرتبطا بكونه جزءا من بنية الوعي الذي يستمرّ، مستندا إلى سرديات موغلة في القدم، فهذا الإدراك لا يخلو من إشارات إلى نمط حياة سائد، وإلى بيئة لها حضورها اللافت في ارتكازها إلى محفزات وأنساق مضمرة بعيدة. ففي القصة الأولى (أدونيس يعود إلى القصر) يقول :جدي قفز في النيل بملابسه، أما أنا فأكلت لحمه)، نجد أن هناك جملة تقريرية كاشفة عن مساءلة مستمرة للوعي الأسطوري المستقر في الذهن قبل أن يلتحم برؤية اليهودية والإسلام وبعض المذاهب المسيحية، فقد كان الخنزير نجسا، وعلى من يلمسه أن ينزل إلى مياه النهر، وهذا يمثل سلوك الجد، ولكن سلوك الحفيد- لأسباب عديدة- تغير إلى النقيض دون الارتباط بالتحديدات السابقة سواء أكانت دينية أم أسطورية خرافية.
فالقصة من خلال المقارنة بين سلوك الجد(السلوك العام) والحفيد تؤسس لسرديتين متناقضتين: الأولى ترتبط بأساطير موغلة في القدم في الميثولوجيا الكنعانية حيث قام أدونيس بقتال خنزير في وادي نهر الكلب بلبنان، مما أدى إلى مصرعهما، ويمثل الخنزير بذلك رمزا للشر والبغض. وقد تم البناء على هذه النواة في الثقافات المختلفة، وأخذت الأسطورة من خلال تنقلها مناحي مختلفة، فرعاة الخنازير في الثقافة المصرية القديمة ممنوعون من دخول المعابد المصرية، ولا يتزوجون إلا من رعاة الخنازير مثلهم. هذا معناه أن وجهة النظر السلبية تجاه الخنزير ليست دينية، بل هي مسألة مشدودة لعصور موغلة في القدم، ومرتبطة بالأسطورة وبميراثها الجمعي، وبتبني الأديان لوجهة النظر السابقة باستثناء بعض مذاهب المسيحية. تتمثل السردية الأخرى في إشارة (أوفيد) في كتابه (التحولات) إلى أن للخنزير محبين وكارهين، ويصل الطرفان في رؤيتهما له إلى حد المغالاة في تقديسه أو النيل منه.
تشكل القصة وعيا لافتا بحدود الأسطورة ببنائها أو إشارتها إلى صراع خفي بين اثنتين على فرد واحد، ولكن الجديد في قصص حسن عبدالموجود أنه لا ينطلق من الأسطورة التي يمكن أن تشكل حدودا لحركة القصة، وتمارس نوعا من التنميط، بل نجد الكتابة- في تباين مع العنوان- تبدأ من الحياة، فالأسطورة محددة، ولكن الحياة منفتحة تستوعب الأسطورة وغيرها، أو تجعلها- على الأقل- تتجلى بشكل جديد. فهناك (الأم) المسلمة، وهناك (دميان) المسيحية والبطل أو الراوي الذي يمثل (أدونيس) في الأسطورة.
انطلاق الكتابة من الحياة يولد فائضا دلاليا في تشكلها، بحيث يشعر المتلقي أن هذه النسخة من الكتابة- القصة- تمثل تجليا مغايرا أو امتدادا ذا ملامح خاصة للأسطورة، ولكنها مشبعة بدفقة أو بحياة جديدة، فالكتابة مشدودة لاستحضار كل السرديات السابقة بإشارات متوالية، ويمكن أن تكون متعارضة أو متجاوبة، ولا يقف السارد- أو منطق القص- موقفا معارضا من سردية معينة بشكل مباشر، هو فقط يجترحها من خلال تقديم الوجه المقابل أو المباين لهذه السردية السائدة، ويلحّ عليه، فيبدو مشدودا – وكأنه يشير من طرف خفي – لاختيار هذه السردية المقموعة بسطوة سردية مهيمنة.
في كل قصص المجموعة هناك اكتشاف لحياة دافقة تعيده لاكتشاف ومعاينة الأسطورة بأنساقها المضمرة، حتى لو كان الإطار العام للقصة إطارا معاصرا في تجليه، فهذه المعاصرة تكفل له مساحة للحركة، ولإدراك التشابهات والتباينات بين السرديات القديمة والآنية. يتجلى ذلك واضحا في قصة(الحمار سعف ذهبي ونبيذ وأحذية قديمة) فهناك في العنوان جمع بين متناقضات، وكلها مرتبطة (بالحمار) انطلاقا من سردية قديمة وارتباط خاص بسردية معاصرة تتشكل في حدود(حمار جدي لأبي) و(حمار جدي لأمي)، فالمقارنة بينهما تؤسس حضورا لسرديتين متقابلتين.
يجمع هاتين السرديتين قول الجاحظ عن الحمار(وللناس في مدحه وذمه أقوال متساوية بحسب الأغراض)، فهو مقدس حينما يرتبط ذكره بالمسيح ودخوله أورشليم والتفاف الناس حوله بالسعف الذهبي كما جاء في عنوان القصة، وويصبح قريبا من دلالة المتعة والغريزة- وإن كان لا يخلو من قداسة- حين يرتبط ذكره (بباخوس)، فالحمار وفق هذا المعتقد حامل المتعة، لأن باخوس- إله الخمر- كان يحمل قنينات النبيذ على حمار، فهو هنا إشارة للبهجة واللذة. أما السردية الأخرى فتتجلى في أسطورة تشير إلى أن آخر من دخل سفينة نوح هو الحمار، وقد كان إبليس يمسكه من ذيله، ويمنعه من الدخول، فقال له نوح: ادخل يا ملعون، فدخل إبليس ومعه الحمار.
وقد تمددت هذه السردية الثانية لتنمو من خلالها سرديات أخرى تؤكدها وتدعمها، وحولتها إلى سردية شبه سائدة ومهيمنة، مثل ارتباط الشيطان بالحمار، فنهيقه إشارة إلى وجوده ورؤيته إياه. تتجلى في القصة الإشارة إلى هذين التوجهين أو النظرتين من خلال المقارنة بين (حمار جدي لأبي) و(وحمار جدي لأمي) بالإضافة إلى السارد الذي يطل في وجه من وجوهه وكأنه (ميداس) الذي يحكم بينهما، ويضع تصنيفا بسمات كل حمار. فميداس كما تقول الأسطور كان حكما في تنافس عزف موسيقي بين(أبوللو) و(مارسياس)، وحكم لصالح الأخير، فعاقبه أبوللو بأن جعل له أذنيّ حمار.
في تشكيله للمقارنة وانحياره للشعبي بعيدا عن السلطوي ثمة إصرار على الانتساب إلى تلك الشريحة الحانية من البشر، وكأنه انتساب قديم( بسبب حياة سابقة بعيدة أحببت الحمير، واعتبرت أنني أحد أفرادها. أمتطيها لكنني لا أتعالى عليها، أوشوشها ولا أنهرها، أمسّد شعر رقبتها ولا أسبها، آمرها بصرامة ولا أضربها. هذه أمور قاسية لا يقوم بها إلا جدي لأبي)، ويقول في جزئية أخرى بشكل واضح (أنا حمار من أيام سيدنا نوح). وفي ظل هذا التماهي يمكن أن نتوقف عند محاولة نفي الاستكانة والتسليم والتبلد بحيث يبدو الحمار- مشابها للرعية المغلوبة على أمرها- رمزا للذلة والمسكنة من خلال إعلاء تأويل جديد لذلك التسليم، فالحمار- في منطق القصة- (هذا الكائن غير المكترث، رمز التجاهل لا الصبر، رمز التعالي لا الدأب، رمز النفور لا الجلد، رمز التباهي لا الكسل). وفي إطار هذه الثنائية التي يمكن أن تكون إشارة للحركة بين توجهين تتشكل سردية جديدة وهي سردية التعالي عن الشكوى وعدم الاكتراث بكل المنغصات والصعاب.
في قصة (القط نصف نوبة حراسة) يستند الكاتب إلى النسق الشعبي الذي يوجد فيه الكثير من القصص الغريبة التي تقترب من الخرافة، ويلحّ على أذهاننا أثناء القراءة سؤال، لماذا يتمّ النهي دائما عن ضرب القطط ليلا؟. العودة إلى هذا الفلكلور ربما تجيب عن هذا السؤال، ففي التراث الشعبي- وخاصة في قرى جنوب مصر- تتناثر قصص عن أرواح التوائم التي تتجسد ليلا في شكل قط للبحث عن الطعام، ويجب أن يحصل عليه وإلا وقع مريضا. تبنى القصة بداية من عنوانها على جزء من الأسطورة فنصف نوبة الحراسة إشارة إلى الليل التي تغادر فيه روح أحد التوائم للتجول ليلا، ويصبح عمل الأم في مراقبة حركته، وإغلاق النوافذ والمرور على الجيران والتنبيه عليهم بعدم ضرب أي قط ليلا.
الاتكاء على الأسطورة في تلك القصص-لارتباط الكتابة بالحياة- لا يؤدي إلى التعبير عنها في شكلها البسيط والفطري الأولي، ولكنها تأتي مزدانة بالحياة في كل تموجاتها، فلن تخلو أي قصة من هذه القصص من الحياتي البسيط أو المعيش، لأنه لا ينطلق من الأسطورة، وإنما ينطلق من إشارات لافتة أو توجه يستدعي سؤالا لغرابته، ولكنه من خلال البحث- أو إيهامنا بالبحث- يكتشف هذا التذويب الخاص بالأسطورة الذي لا ينفي وجودها، بل يثبت وجودها واستمرارها في أشكال مغايرة على نحو ما يمكن أن نجد في قصة (الدودة حديث دافئ في المقبرة) أو في قصة ( أبو دقيق تراب أبيض مقدس). فهناك إشارات دامغة للسياسي والاجتماعي والحياتي، وهذا يفقد الأسطورة صلابتها وحدودها المقررة، ويجعلها في معرض دائم للتجدد والتكرار.
اجتراح النوع
لا يقدم حسن عبدالموجود في مجموعته قصصا عادية، وإنما يقدم لنا سرديات المعرفة، بامتداد الوعي الموغل في القدم حتى البدايات الأولى، لا يقدم لنا قصصا عن الحيوانات والطيور، كما فعل السابقون سواء من الكتاب العرب أو الأجانب، ولكنه مهموم بتقديم حكايات قديمة تركت مسها أو أثرها في تنميط المدى أو الدوائر الدلالية المحيطة بكل كائن، فهو يلح على تقديم مجمل الرؤى على مرّ التاريخ مستندا إلى تنوع الثقافات، فإذا عرض إلى حالة معرفية مرتبطة بحيوان أو طائر، فلا يقدمها مستقرة وادعة، وإنما يناوشها بتقديم الوجه المقابل.
وقد كان لهذا التوجه الكتابي آثاره في خلخلة مؤسسات النوع الأدبي، وفي اجتراحات فنية للنوع وثيقة الصلة به، فالزمن السردي على سبيل المثال لم يعد محددا، وليس المقصود هنا حركة الزمن من خلال الآليات المعروفة للتغلب على خطيته، بل المقصود تعدد اللحظات الزمنية المشدودة إلى سرديات وخطابات يتمّ دمجها في القصة دون شعور بحدة المغايرة أو صعوبة النقلة من سردية إلى أخرى، لأن الجامع بينها قدرة الخيال لدى السارد في استجلاء وتجميع سرديات مختلفة يكيفها داخل عالمه الكتابي المرتبط بحادثة واقعية حياتية، ولكنها لطبيعتها الخاصة تظل دائمة الإشارة إلى الخارج الأسطوري، فهي تتداخل معه وتنفصل في آن، تتداخل معه في ثبات الروح التي تقاوم الزمن وتتعاظم على راهنيته، وتنفصل عنه في بوحها التلقائي للدلالة على عالم آني ما زالت هناك إمكانية على تلقيه بشكل منفصل بعيدا عن الأساطير والخرافات اللافتة للنظر.
في قصة (الحمار سعف ذهبي ونبيذ وأحذية قديمة) نجد أن كل وصف تفسيري من هذه الصفات المسدلة ينتمي إلى سردية لها زمنها، ولها خطابها الذي يكفل إطارا محددا، (فالسعف الذهبي) يشير إلى احتفال البشر بقدوم المسيح إلى أورشليم، مولدا سردية التقديس. أما الوصف الثاني (نبيذ) فيشير إلى سردية (باخوس)، وارتباطها بالمتعة واللذة والقوة الجنسية، وهي تشير إلى لحظة زمنية سابقة للأولى. ويجيء الوصف الثالث والأخير(وأحذية قديمة) مرتبطا بسفينة نوح، وميلاد سردية سلبية قديمة تجاه الحمار ظلت مهيمنة إلى اللحظة الراهنة، وقد كشفت نهاية القصة عن استمرار هذه الهيمنة.
مع السرديات السابقة التي تشكل طبيعة النظرة إلى ذلك الكائن نحن أمام ثلاث لحظات زمنية مختلفة وسياقات متباينة، ولكنها أحكمت وجودها وفاعليتها، وتعاظمت على سياقاتها المولّدة باستمرار في المشاركة في صناعة الخيال المصاحب لذكر الحيوان. ففي القصص التي تنتهج إطارا معرفيا نجد دائما هذه الحركة بين اللحظات الزمنية المختلفة استنادا إلى فاعلية الخيال التي ربما تحتاج إلى مثير شكلي لتمارس الذاكرة دورها في الارتداد والمعاينة والمقاربة.
وإذا كان الزمن على هذا الشكل من التعدد داخل الإطار المعرفي الذي يجمع ويكيف هذا التعدد، فإن المكان أيضا هلامي، وليس هناك اهتمام بتشييده أو تعمد تشكيله، فالحركة الفاعلة محسومة للفكرة، وفي طريقة تمددها متجاوبة أو متنافرة مع سابقتها. فتأمل قصص المجموعة يكشف عن هذا الاهتمام، خاصة في قصة (القط نصف نوبة حراسة)، أو في قصة (الدودة حديث دافئ في المقبرة) حيث تحفل الأخيرة بسرديات فلكلورية خاصة تمارس دورها في تشكيل الوعي الجمعي والإدراك مثل الساحرة وقدرتها على إخراج الدود من الأذن.
ربما تكون طبيعة السارد أو الراوي في قصص المجموعة أو بشكل قد يكون أكثر صحة وعي السارد هو أكثر الأشياء حضورا وشدا للانتباه، فوعي السارد وعي متطور نامٍ لايقف عند مرحلة عمرية واحدة. ربما يكون المثير مرتبطا بأسئلة ووعي الطفولة على نحو ما يمكن أن نرى في القصة الأخيرة (أبو دقيق تراب أبيض مقدّس)، فالدلالة الأولى المستقرة لكلمة دقيق ظلت لها الفاعلية في محاول استيلاد أفق جديد بعيدا عن المستقر والمقرر، فهناك محاولة لتشكيل أفق يتمحور حول قداسة تنفيها دلالة سلبية ممتدة بشكل خاص منطلق من النفعية.
ولكن هذا الوعي البسيط لا يستمرّ فاعلا في قصص المجموعة، بل بتجاوب معه وعي مشدود للمعرفة والاستقصاء ومعاينة التشابهات والاختلافات في أغلب قصص المجموعة، بتجلى ذلك حين نعاين مجموعة القصص والأساطير التي تحفل بها القصص، فكل هذه المعارف والأساطير تتنافى مع فكرة الوعي الوحيد والمحدد. ولهذا يمكن أن تكون كتابة حسن عبدالموجود في هذا الكتاب كتابة تنطلق من الحركة للوصول إلى المعرفة المستندة إلى وعي وإدراك. ولفظة (الكتابة)- لتوصيف الكتاب وتحديد نوعه وجنسه- مقصودة لذاتها، فليس هناك تجل قار لأسس النوع، وليس هناك-ربما لشعور المؤلف بذلك وحيرته في تصنيفه- أي إشارة تجنيسية تضعه داخل دائر نوع محدد.
وربما يأتي العنصر الأكثر إلحاحا في هذه المجموعة لتغييب أسس النوع متمثلا في غياب فكرة الصراع بالمعنى المحدد والمعروف، فليس هناك صراع، وإنما هناك وعي وإدراك ناميان ليسا محددين بزمن، ولكنهما موضوعان تحت تأثير المساءلة المبطنة المستمرة الهادئة من خلال تجاور الطبقات المعرفية المتراكمة أو المتوازية. فالكاتب حين يقدم توجهات معرفية قد تكون متباينة أو متجاوبة مع حيوان أو طائر لا يؤسس لفكرة الصراع، بل يؤسس لفكرة التجميع والحركة من النقيض إلى النقيض، فالقصص تشير إلى أنساق أو توجهات تتوالد بالتدريج على فترات زمنية متباعدة، وهذا ينفي جزئية الصراع داخل عملية الكتابة، ويجذرها داخل الذهن والوعي والمعرفة، فالصراع ليس في حبكة الكتابة، وإنما صراع طبقات معرفية تتجاور آنيا وإن كانت تنتمي إلى لحظات زمنية متباينة.
فهذا الصراع الجديد الخاص بالطبقات المعرفية صراع من نوع خاص، لكونه لا ينفي التوجه الآخر أو الطبقة الأخرى المهيمنة، هو فقط يهشم فرادتها وسيطرتها وهيمنتها من خلال الإشارة إلى وجود طبقة أو طبقات أخرى. فحين يقول ظريف في القصة الأولى( الخنزير أدونيس يعود إلى القصر)(الخنزير شريك في البيوت، وهو كائن طيب، معشره لطيف، يأكل أي شيء، لكنهم لا يحشونه كما يقول أقاربي طوال اليوم بالقمامة، كما لا يتركونه يأكل روثه) فإننا أمام طبقة مغايرة للطبقة السائدة، لكنها لا تنفيها، هي فقط تجرح هيمنتها مستندة في ذلك السياق إلى بعض الآراء التي جعلت التحريم مرتبطا بطبيعة إعاشته أو نوع طعامه، فإذا انتفت وفق منطق وجهة النظر الجديدة يصبح لها مشروعية جنبا إلى جنب مع الطبقة المهيمنة.
وانطلاقا من غياب الصراع بمعناه النمطي، وتحوله إلى تجاور طبقات ليس بينها صراع إلا ما يؤدي إليه هذا التجاور من زلزلة الهيمنة لدى كل طبقة، نجد أن المجموعة القصصية مملوءة بإشارات معرفية تستند إلى تجارب حياتية ممتدة، وفي صياغتها يشعر المتلقي أن هناك بترا للسرد أو تجاوبا لأنها تمثل لحظة الوصول أو النتيجة الخاصة بالسرد وعرض الطبقات ففي قصة العقرب يقول السارد عن والده( كان جادا وبإمكان هذه الجدية أن تنظم حياتنا، ولكننا نحتاجها بقدر، وإلا ستحولنا إلى قضبان تنتظر عبور القطارات الغريبة فوقها، ماذا ستكسب تلك القضبان في النهاية لو اعترفنا لها).
وفي قصة (الديك خمسة ذقون ناعمة) تتجلى هذه الجمل أو الجزئيات المعرفية من خلال الربط بين القصة الواقعية الخاصة بالبطل(صف ضابط) وتحوله إلى ضابط والديك، في وجود إحساس لا يبارحه بالدونية تجاه الضباط العاملين الآخرين، يقول النص مشيرا إلى الرتابة أو إلى أثر الانحناء المستمر أو الارتباط بمنزع وحيد مستكين في مقاربة الحياة( الحياة الخالية من الشوائب، الحياة المكونة من عنصر واحد، الحياة الرتيبة، تكون قابلة بسهولة للخدش، والإنسان الذي لا يعرف سوى الاستقامة قابل للكسر).
الكتابة في مجموعة البشر والسحالي كتابة معرفية في الأساس وثيقة الصلة بمقاربة الحياة في انفتاحها على الواقعي، وارتباطها بالأسطوري، وما يحدثه من تحديد نسق أو طريقة مقاربة الحياة، والنظر إلى الوجود وفق مكوناته وجزئياته التي كانت تعيش- الإنسان والحيوان والطير- قريبة من بعضها البعض، وبالرغم من من دور المدنية في خلق الحواجز بين عالم البشر وعالم الحيوان والطيور إلا أن الأساطير ظلت فاعلة بتجليها وفق رموز تشير إلى وجودها البعيد.


 الخبر الثقافي موقع يهتم بكافة النواحي الثقاقية بمختلف مجالاتها وتغطية الأخبار الفنية .
الخبر الثقافي موقع يهتم بكافة النواحي الثقاقية بمختلف مجالاتها وتغطية الأخبار الفنية .